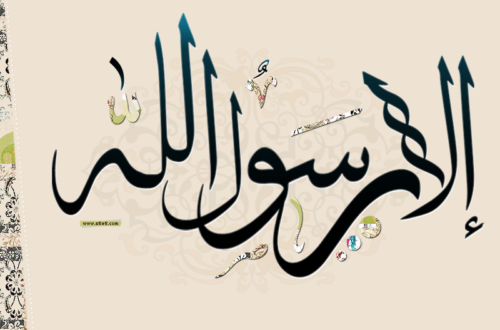الهجرة النبوية .. دروس وعبر
بسم الله الرحمن الرحيم
الهجرة النبوية: الدروس والعبر
مهران ماهر عثمان
غرة محرم 1442هـ
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فلا يخفى على مسلم ما لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أثر كبير في إحداث النصرة والتمكين لدين الإسلام، وسرد أحداث الهجرة كثيرٌ مبثوث في كل كتاب من كتب السير، ولذا أحببت ألا أنقل شيئاً من ذلك، وأن أجعل هذا المقال عن دروسها وما يستفاد مما حدث فيها.
أول درس نستفيده: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر/95].
لقد اجتمع المشركون في دار الندوة ليصلوا إلى طريقة يتخلصون بها من نبينا صلى الله عليه وسلم، وتمخض اجتماعهم عن ثلاث نقاط حكاها الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال:30]. فهل تمكنوا من ذلك؟ لقد حفظ الله نبيه من كيدهم، قال الإمام السعدي رحمه الله في هذه الآية: “﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله: أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة” [تفسير السعدي، ص435]. أحاط بداره أبو جهل، وأبو لهب، والحكم بن أبي العاص، وعقبة، والنضر بن الحارث، وأبي بن خلف، وأمية، إلى آخر قائمة سوداء قاتمة؛ ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تم ذلك لهم؟ خرج نبينا صلى الله عليه وسلم أمامهم بعدما ألقى الله النعاس عليهم، ووضع التراب على رؤوسهم، ﴿فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف:64].
والله متمٌّ نوره
1442 عاماً والمحاولات مستمر لإطفاء نور الله! فهل تمَّ ذلك؟!! المسلمون يزداد عددهم في كل يوم، والكنائس تغلق وتُشترى لتكون مساجد في عقر دار الكفر.
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 33]، [الصف: 9].
وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) ﴾ [الفتح: 28].
مما أُيِّد به نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته أنَّ الله طوَّع له كلَّ شيء.
لم يصل أحد من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سراقةَ بن مالك، ولما رجع منهما جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردهم، فكان في الأول النهار باحثاً عنهما، وصار في آخره حارساً لهما.
أيَّده بالرمل لما ساخت فيه يدا فرس سراقة.
طوع اللهُ له الأزلام في يد سراقة لما خرج الذي يكرهه؛ ألا يضرهم.
أيَّده الله بالنعاس لما أُلقي على قلوب الكافرين، فخرج آمناً بينهم من بيته.
طوَّع الله له الشاة في خيمة أم معبد، فلقد نظر إلى شاة خلَّفها الجَهد والهُزال، فدعا، ومسّ بيده ضرعها، وسمى الله، فامتلأ باللبن ضرعُها.
طوَّع له كافراً يدلُّه على الطريق.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2، 3].
من دروسها: أنه ينبغي الاستفادة من جميع الطاقات لخدمة دين الإسلام.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج بنفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه، ويحرسه، ويؤنسه.
بنته أسماء رضي الله عنها كانت تأتي إليهما بالطعام وهما في الغار.
عبد الله ابنه كان يأتيهما بخبر القوم.
عامر بن فُهَيْرَةَ مولى أبي بكر يأتيهما باللبن، ويتتبع أثر عبد الله لينسخه.
لقد قدَّم الصحابة شيئاً كثيراً لدينهم، فماذا قدَّمنا نحن!؟
قال تعالى: ﴿وَلَو أَنّا كَتَبنا عَلَيهِم أَنِ اقتُلوا أَنفُسَكُم أَوِ اخرُجوا مِن دِيارِكُم ما فَعَلوهُ إِلّا قَليلٌ مِنهُم﴾ [النساء: ٦٦].
ماذا لو قيل لك: اخرج بأهلك، واترك مالَك وبيتَك! مَن يقدر على تحمل ذلك؟!
المهاجرون.
فهم من هؤلاء القليل، رضي الله عنهم وأرضاهم.
عند ابن أبي حاتم في التفسير، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أمرتني بقتل نفسي لفعلتُ ذلك!
فقال له الصادق، المصدوق: “صدقتَ”.
وعند ابن جرير قال له رجل من أصحابه: لو أمرتنا بترك بيوتنا لفعلنا. فقال: “إنَّ من أمتي لرجالاً الإيمانُ أثبت في قلوبهم من الجبال الرَّواسي”!
تركوا لله بيوتهم، فترك الله عليهم في الآخرين: رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدِّين.
عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من داره.
وأبو بكر الصديق لما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار دخل قبله، وعلل ذلك بقوله: يا نبي الله إن كان فيه شيء أصابني دونك.
وابنته أسماء رضي الله عنها كانت تصعد الجبل بطعامهما، هذا الجبل الذي يحتاج من الرجل القوي إلى ساعتين ليبلغ غاره الذي في أعلاه، وليس معها أحد، فعلت ذلك في هدأة الليل؛ لئلا يتعرف المشركون على مكانهما!
هذا ما قدمته امرأة منهنَّ لدينها، فماذا قدمنا نحن لهذا الدين الذي وصل إلينا على أشلائهم وأنهار دمائهم؟!
أُخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ملاعب صباهم، وهاجروا إلى مكان لا أهل لهم فيها، ولا والد ولا ولد.
لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل شيء؛ بالمال، والوطن، والأهل.
وتأمل في هذا الحديث لتعلم صعوبة الأمر بالنسبة للمهاجر الذي يترك بلده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، ” فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» رواه النسائي.
ومعنى ذلك: أن الفرس المربوط بحبل، لا يتحرك إلا في مساحة معينة يسمح له بها طول هذا الحبل، وكذلك المهاجر؛ فإنه يستوحش المكان، ويشعر بالغربة فيه، فلا تنبعث نفسه في كثير من الأشياء لهذا الشعور الذي يلازمه.
فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل ذلك ليظهر دين الله تعالى، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: 40]، وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 8، 9].
لا عجبَ أن يصدر هذا الفعل عن الصحابة؛ فهم مَن قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم: «إن الله اختار أصحابي على الثقلين» رواه البزار، لكن يبقى سؤال، من وجد إجابته الآن فليحمد الله، ومن لم يجدها، فما زالت الفرصة قائمة ليصنع شيئاً يجيب به عنه بما يسره: ماذا قدمت لدين الله؟
من دروسها أنها تُعَرِّف المسلم بحق المهاجرين علينا والأنصار.
هذه الكوكبة التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت لإعزاز دين الله.
ولذا امتلأ القرآن الكريم بمدحهم وبيان فضلهم، ألا يكفي عباد الله دليلاً على فضل المهاجرين هذه الحادثة:
أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنَّ الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة: هل لك حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ يريد حصناً لدوس كان في الجاهلية، قال جابر: فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فَاجْتَوَوْا المدينة، فمرض، فجزع؛ فأخذ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنةٌ، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم وليديه فاغفرْ».
هذا من المهاجرين قتل نفسه، فمال حال الصحابة الذين هاجروا ولم يقترفوا مثل هذا الإثم، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله بهم دينه؟! ماذا لهم عند الله تعالى؟
منها: أنَّ من هدي الأنبياء إحسان الظن بالله، والصدق في التوكل عليه، وهذا سبيل النجاة من كل كرب.
لقد بلغَ المشركون الغار، وأبو بكر الذي قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر» قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا؟ فماذا قال سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما». ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:40].
ولما علم الصديق رضي الله عنه بأمر سراقة، وأنه ظفر بهما، شكا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكرر له: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما».
وأغرب من ذلك أنه مُطارد قد يمَّم وجهه شطر طيبةَ يُبَشِّر سراقة بنَ مالك بسواري كسرى!
خرج متخفيا، نعم.
لكنه موقنٌ بوعد الله له.
ولما بُشِّر سراقة بذلك كان مشركاً يعبد الأصنام، ويستقسم بالأزلام.
فمَن أعلمه أنه يسلم؟
وأنَّ المسلمين يدكُّون معاقلَ كسرى؟
وأن سراقة يبقى إلى ذاك الوقت؟
يُحمل السواران إلى مدينته في عهد الفاروق، ويَلبسهما سراقة!
لو لم يكن في دلائل النبوة إلا هذا لكفى.
إنّا لنشهد أنَّ محمداً رسولُ الله حقَّاً.
صلوات الله وسلامه عليه
﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال:49]
﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق :3]
إنّ هذا ليذكرنا بما صدر عن إبراهيم عليه السلام لما أضرم قومه النار له وصارت ألسنتها تتخطف الطير الذي يسبح في رحب الفضاء، وهو في طريقه إليها بدا له جبريل عليه السلام قائلاً: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم.
يذكرنا بموسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه – وكان البحر أمامهم، وفرعون خلفهم، والجبال الشاهقة عن أيمانهم وعن شمائلهم– قالوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾. فماذا قال؟ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء :62].
فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه، فقد قال تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» متفق عليه.
وفي الخبر: «ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات السبع والأرَضُون السبع إلا وجعلت له من بينهنَّ فرجاً ومخرجاً».
من الدروس: أنَّ المسلم عفيف لا يسأل الناس شيئاً.
فسراقة لما لحق بهما عرض عليهما الزاد، قال: فلم يسألاني. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»؟ -أي من يضمن لي– فقال ثوبان: أَنَا. قَالَ: «لَا تَسْأَلْ النَّاسَ شَيْئًا». فكان إذا وقع سوطه لا يطلب من أحدٍ رفعه، بل ينزل من على دابته ويأخذه.
من دروسها أنّ الإسلام دين وفاء لا يعرف الغدر
لقد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك كتاب أمان، ولما جاء إليه سراقة بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: «هذا يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ»، فأسلم سراقة. رواه الطبراني في الكبير.
وقال في أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» رواه البخاري. قالها وفاءً له؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء، ثم بعث إلى الأخنس بن شُرَيق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك، ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله.
ولما ذهب حُيَي بْنُ أَخْطَب النّضْرِيّ إلى كَعْب بْن أَسَدٍ الْقُرَظِيّ الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد حيي يوم الأحزاب من كعب أن ينبذ عهده، فكان فيما قاله له كعب: “وَيْحَك يَا حُيَيّ فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ؛ فَإِنّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمّدٍ إلّا صِدْقًا وَوَفَاءً” [سيرة ابن هشام 2/220].
ولما فتح مكة أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وصلى في جوف الكعبة، جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إلَيْهِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ فِي يَدِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اجْمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السّقَايَةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْك. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ»؟ فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَك يَا عُثْمَانُ، الْيَوْمُ يَوْمُ بِرّ وَوَفَاءٍ».
ومنها: أنَّ مع العسر يسراً، وبعد الليل فجراً
ابتلي المسلمون بمكة وعذبوا، ففي صحيح البخاري عن خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».
فكانت لهم دولة بعد ذلك، وظهر أمرهم، وعلت كلمتهم، فالحق منصور ولكنه ممتحن كما قال الشافعي رحمه الله.
إن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم لما بلغ المدينة اهتم بأمرين:
بنى المسجد، وآخى بين المهاجرين والأنصار. وهذا يدل على أهمية هذين الأمرين.
فالمساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتآخي بين المسلمين سبيل النصر وإعزاز الدين، والعكس بالعكس، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال :46].
ومن دروسها أنّ إعلاء كلمة الله في أرض الله لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله.
وهذا ما قرره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»أخرجه أبو داود.
تنبيه
غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، وفي 12 ربيع الأول دخل إلى المدينة المباركة، وكان قد مكث أياماً قبلها في قباء.
أما العزم على الهجرة فكان في شهر الله المحرم ، قال ابن حجر رحمه الله: “وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ –مُبتدأ السنة الهجرية- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّم” [فتح الباري لابن حجر (7/ 268)].
رب صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.