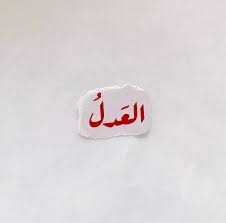يوم عرفة: فضائله ووظائفه
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم عرفة: فضائله ووظائفه
مهران ماهر عثمان
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فهذه وقفات مع يوم عظيم من أيام الله؛ فإنَّه يجدُر بالمسلم أن يتعرَّض فيه لنفحاتِ ربه، وهو يوم عرفة.
تحديد يوم عرفة
هو اليوم التاسع من ذي الحجة.
ومن اليوم الثامن في هذا الشهر إلى الثالث عشر لكلِّ يوم اسمٌ يُعرف به:
فالثامن: يوم التروية.
والتاسع: عرفة.
والعاشر: يوم العيد، والنحر، ويوم الحج الأكبر. وسمي بذا لأن معظم أعمال الحج تقع في هذا اليوم، من رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والنحر، والطواف، والسعي.
والحادي عشر: يوم القر؛ لأن الحجاج يقرون في منى ولا ينفرون في هذا اليوم.
والثاني عشر: يوم النفر الأول.
والثالث عشر: يوم النفر الثاني.
وهذه الثلاثة الأخيرة هي أيام التشريق.
فضله
1/ يوم عرفة يوم أقسم الله به.
قال تعالى:﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود﴿ [البروج: 1-3].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» رواه الترمذي.
وقال سبحانه:﴿ وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر﴾ [الفجر: 1-3].
قال ابن كثير رحمه الله:” قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة؛ لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر؛ لكونه العاشر. وقاله ابن عباس، وعكرمة، والضحاك أيضاً” [تفسير القرآن العظيم (8/ 390)].
2/ يوم عرفة يوم إكمال الدين.
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ” رواه الشيخان.
3/ وهو يوم عيد لأهل الموقف، يجتمعون فيه في مكان واحد.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» رواه أحمد.
4/ وربنا يباهي ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا» رواه أحمد.
قال ابن عبد البر رحمه الله: “وهذا يدلُّ على أنهم مغفورٌ لهم؛ لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران والله أعلم” [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 120)].
وقال المناوي رحمه الله –معلقاً على هذا الحديث-: “وهذا يقتضي الغفران وعموم التكفير؛ لأنه لا يباهي بالحاج إلا وقد تطهَّر من كل ذنب، إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر، فينتج أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات، ولا حَجْر على الله في فضله، ولا حق بالحقيقة لغيره” [فيض القدير (2/ 354)].
وهذه الاستنباط جاء مصرحاً به في حديث الأنصاري الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَقْبَلَ عليه فَقَالَ له نبينا صلى الله عليه وسلم: «سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ»؟ قَالَ: فَذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ. قَالَ: «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ حَلْقِكَ رَأْسَكَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ»؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. قَالَ: «أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً، وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَ اللَّهُ عَنْكَ. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَة. فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» رواه الطبراني في الجامع الكبير.
5/ أنه يوم العتق من النار.
تقول عَائِشَةُ أم المؤمنين رضي الله عنها: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ»؟ رواه مسلم.
6/ وهو يوم ذلٍّ للشيطان الرجيم.
فعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ» رواه مالك في الموطأ.
خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب -كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل -، وربا الجاهلية موضوع، وأول رباً أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة، وإنَّ لكم عليهنَّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن غير مبرِّح، ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت رسالات ربك، وأديت، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد» [هذه مجموعة روايات الحديث كما رتبها الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم].
وظائف يوم عرفة
1/ الصوم.
قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم. وفي لفظ له: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
والسنة للحاج أن يفطر في يوم عرفة. قال الإمام مسلم في صحيحه: “بَاب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ مسلم”، ثم أورد حديث أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. رواه الشيخان.
أما حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرف بعرفة فضعيف. [انظر السلسلة الضعيفة، حديث رقم (404)].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه” رواه عبد الرزاق في المصنف.
وقال عطاء: “من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم” رواه عبد الرزاق.
وفي البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صامت عرفة بعرفة، وهذا أفضل في حق من لا يضعف عن عبادة الذكر والدعاء [فضائل العشر للطريفي، ص44].
ويجوز صيام عرفة لمن عليه قضاء من رمضان، ويقضي بعده؛ فوقت القضاء موسع.
2/ الدعاء.
فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي (8/ 482) “«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ»؛ لِأَنَّهُ أَجْزَلُ إِثَابَةً وَأَعْجَلُ إِجَابَةً”.
فلو لم يكن الدعاء فيه مستجاباً لما كان خير الدعاء.
وقد اختلف العلماء هل هذا الفضل للدعاء يوم عرفة خاص بمن كان في عرفة أم يشمل باقي البقاع، والأرجح أنه عام، وأن الفضل لليوم، ولا شك أن من كان على عرفة فقد جمع بين فضل المكان وفضل الزمان.
3/ التَّعريف.
هو قصد غير الحاج المسجد يوم عرفة والمكث فيه للدعاء والذكر.
وهو ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم [فضائل العشر للطريفي، ص 40-41].
وهذه خلاصة قيمة تتعلق به كتبها الشيخ الدكتور أحمد الخليل حفظه الله: “رؤوس الأقوال فيه ثلاثة: القول الأول: مستحب. القول الثاني: مكروه. وقيل: من جملة البدع. القول الثالث: مباح لا مستحب ولا مكروه. وهذا القول الثالث هو منصوص الإمام أحمد، ونصره ابن تيمية، وترجيحه ظاهر صنيع ابن رجب، وهو -إن شاء الله- أعدل الأقوال، وأصحها. قال ابن تيمية: “فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي ﷺ شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة”. وقال ابن تيمية أيضا: “ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله ﷺ…”. فإن قيل: ضابط البدعة منطبق عليه تماما فلم لا نسميه بدعة؟ فالجواب: بأنه يوجد ضابط في هذا الباب، يعمل به الإمام أحمد وابن تيمية وابن رجب وغيرهم. وهو: أن ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، أي لا يطلق عليه اسم البدعة، ولا يلزم من هذا ترجيحه والعمل به. قال ابن رجب: “واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة، وكان الإمام أحمد لا يفعله، ولا ينكر على من فعله؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة” [ لطائف المعارف، ص:272]. وقد لخص ابن رجب الموضوع كاملا في هذين السطرين” [كتبه: د. أحمد بن محمد الخليل، 4 / 12 /1443].
وهذا نص ما قاله ابن تيمية رحمه الله: “وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَهُ لِأُمَّتِهِ؛ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ هَذَا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ؛ بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا مِمَّا سَاغَ فِيهِ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ أَوْ مِمَّا لَا يُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ لَا لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ أَوْ يُقَالُ فِي التَّعْرِيفِ: إنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَحْيَانًا لِعَارِضِ إذَا لَمْ يُجْعَلْ سُنَّةً رَاتِبَةً. وَهَكَذَا يَقُولُ أَئِمَّةُ الْعِلْمِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ: تَارَةً يَكْرَهُونَهُ وَتَارَةً يُسَوِّغُونَ فِيهِ الِاجْتِهَادَ وَتَارَةً يُرَخِّصُونَ فِيهِ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ سُنَّةً، وَلَا يَقُولُ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ: إنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُقَالُ فِيمَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسُنَّ وَلَا أَنْ يَشْرَعَ؛ وَمَا سَنَّهُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ فَإِنَّمَا سَنُّوهُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ مِنْ سُنَنِهِ وَلَا يَكُونُ فِي الدِّينِ وَاجِبًا إلَّا مَا أَوْجَبَهُ وَلَا حَرَامًا إلَّا مَا حَرَّمَهُ وَلَا مُسْتَحَبًّا إلَّا مَا اسْتَحَبَّهُ وَلَا مَكْرُوهًا إلَّا مَا كَرِهَهُ وَلَا مُبَاحًا إلَّا مَا أَبَاحَهُ” [مجموع الفتاوى (1/ 282)].
وقال ابن قدامة رحمه الله: “قال القاضي: ولا بأس بـ “التعريف” عشية عرفة بالأمصار (أي: بغير عرفة)، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله – أي: الإمام أحمد- عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد، وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا، وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة” [المغني (2/ 129)].
3/ التكبير:
وهو قسمان:
مطلق، وهذا يكون في العشر كلها، ومقيد بدبر الصلوات، وهذا يكون لغير الحاج من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
قال ابن تيمية رحمه الله: “وفي الحديث الآخر الذي في السنن وقد صححه الترمذي: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله». ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث، ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم” [ مجموع الفتاوى (24/ 222)].
وقال الإمام الشافعي رحمه الله -في التكبير في الفطر-: “فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى” [الأم (1/ 462)].
هل للحج فضل زائد إذا وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة؟
لا.
وأما حديث: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة»، فقد قال الألباني رحمه الله: “حديث باطل لا أصل له” [سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم (207)].
مسألة: حكم إفراد الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة؟
من المعلوم أنه قد ورد نهيٌ عن إفراد الجمعة بالصيام في أحاديث صحيحة، منها:
ما ثبت في الصحيحين، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».
ومنها:
ما روى مسلم في صحيحه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».
قال عبد العظيم آبادي رحمه الله: “اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِفْرَادِ الْجُمُعَةِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ” [عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ 49)].
وتزول هذه الكراهة إذا وافق صوماً يصومه المسلم بنص الحديث السابق.
قال ابن قدامة رحمه الله: “وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: صِيَامُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ أَنْ يُفْرَدَ، ثُمَّ قَالَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صِيَامٍ كَانَ يَصُومُهُ، وَأَمَّا أَنْ يُفْرَدَ فَلَا. قَالَ: قُلْت: رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، فَوَقَعَ فِطْرُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَصَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِطْرُهُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَصَامَ الْجُمُعَةَ مُفْرَدًا؟ فَقَالَ: هَذَا الْآنَ لَمْ يَتَعَمَّدْ صَوْمَهُ خَاصَّةً، إنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجُمُعَةَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: لَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الْجُمُعَةِ” [المغني لابن قدامة 3/ 170].
فهذا الذي قاله الإمام أحمد: “ إنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجُمُعَةَ”، يوضح المراد من الحديث، أنه يكره إذا صامه لكونه يوم الجمعة، أما لو صامه لكونه عاشورلااء أو عرفة فلا كراهة في ذلك.
وقال ابن حجر رحمه الله: “وَيُؤْخَذُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ جَوَازُهُ لِمَنْ صَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوِ اتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُومُ أَيَّامَ الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ مثلا أَو يَوْم شِفَاء فلَان” [فتح الباري لابن حجر (4/ 234)].
أي: إذا نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم يوم جمعة.
وذكر ابن عثيمين رحمه الله أنه لو أفرد الجمعة لكونه يوم عطلة يسهل صومه، لا لكونه جمعةً، فلا بأس بذلك، قال رحمه الله: “فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك” [الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 477)]. فلا ينبغي لمسلم أن يزهِّد الناس في إفراد الجمعة بالصوم إذا صادف عرفة أو عاشوراء.
رب صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.