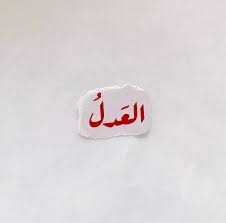صوم التطوع
بسم الله الرحمن الرحيم
صيام التطوع
مهران ماهر عثمان
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ فقد ندبت الشريعة إلى صيام بعض الأيام وبيَّنت فضل ذلك، ولعل من المناسب بعد انقضاء رمضان أن يُذكَّر المسلم بذلك؛ لئلا ينقطع عن عبادة الصوم([1]).
وصوم التطوع قسمان:
الأول تطوع مطلق.
والثاني: مقيَّد.
التطوع المطلق.
وهو المندوب فعله في الشرع من غير تقييد له بخصوصه، كمن أراد أن يصوم يوماً أو يومين أو ثلاثة، فله أن يصوم في غير الأوقات المنهي عن صيامها.
التطوع المقيَّد.
وهو الذي ورد في الشرع استحبابه بخصوصه، كصوم يوم عرفة.
وكل نصٍّ يدل على فضل الصيام عموماً يندرج تحت عمومه التطوع المطلق والمقيد، نحو حديث أبي سعيدٍ رَضِيَ الله تعالى عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «من صام يومًا في سبيلِ اللهِ، باعَدَ اللهُ تعالى وَجْهَه عن النَّارِ سَبعينَ خريفًا» رواه الشيخان.
وهو أقسام عديدة، وهي:
الست من شوال
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه مسلم.
وعن ثوبانَ رَضِيَ الله تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «صيامُ شَهرِ رَمَضانَ بِعَشرةِ أشهُرٍ، وسِتَّةُ أيَّامٍ بَعْدهُنَّ بِشَهرينِ، فذلك تمامُ سَنَةٍ» رواه أحمد والنسائي في الكبرى، وهو في صحيح الجامع للألباني (3851) “([2]).
التسع من ذي الحجة
فعن هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: “حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ” رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (2372).
وصومها مستحب عن الأئمة الأربعة، لا خلاف بينهم في ذلك.
ولا يشكل على هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: “مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ”.
قال ابنُ القيّم رحمه الله بعد أن أوردَ هذه المسألةَ: “والمثبِت مقدَّمٌ على النّافي إن صح”([3]).
وقال النووي رحمه الله مزيلاً هذا الإشكال: “قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله… فيتأول قولها: “لم يصم العشر” أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هُنَيْدَة بنِ خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كلِّ شهر”([4]).
وربما صامها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك صيامها خشية أن تفرض كما ترك الاجتماع في صلاة الليل في رمضان لذات العلة، فأخبرت كل واحدة بما رأته من حاله.
ولا ريب أنَّ الصوم داخل في عموم العمل الصالح الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار منه.
وفي هذه التسع يوم عرفة، وفي صومه أجر كبير، فعن أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم. وفي لفظ له: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
والسنة للحاج أن يفطر في يوم عرفة. قال الإمام مسلم في صحيحه: “بَاب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ مسلم”، ثم أورد حديث أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. رواه الشيخان.
أما حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرف بعرفة فضعيف([5]).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه” رواه عبد الرزاق في المصنف.
وقال عطاء: “من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم” رواه عبد الرزاق.
الصوم في شهر الله المحرم
عن أبى هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه يرفَعُه، قال: سُئِلَ- أي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أيُّ الصَّلاةِ أفضَلُ بعد المكتوبةِ؟ وأيُّ الصِّيامِ أفضَلُ بعد شَهرِ رمضانَ؟ فقال: «أفضَلُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ المكتوبةِ، الصَّلاةُ في جَوفِ اللَّيلِ. وأفضَلُ الصِّيامِ بعد شَهرِ رَمَضانَ، صِيامُ شَهرِ اللهِ المُحَرَّم» رواه مسلم.
صوم عاشوراء
عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: «صيامُ يومِ عاشُوراءَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه» رواه مسلم.
صوم تاسوعاء
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: «لئِن بقيتُ إلى قابلٍ، لأَصُومنَّ التَّاسِعَ» رواه مسلم.
وصوم تاسوعاء مستحب باتفاق المذاهب الأربعة.
صوم أكثر شعبان
عن عائشةَ رَضِيَ الله تعالى عنها قالت: “ما رأيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكثَرَ صيامًا منه في شَعبانَ” رواه الشيخان. ولهما عنها: “كان يصوم شعبان إلا قليلاً”.
وحدث أسامةُ بنُ زيد رضي الله عنهما أنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه النسائي، وحسنه الألباني.
صوم الاثنين والخميس
عن أسامةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصومُ يومَ الاثنينِ والخَميسِ، فسُئِلَ عن ذلك، فقال: «إنَّ أعمالَ العِبادِ تُعرَضُ يومَ الاثنينِ والخَميسِ، وأُحِبُّ أن يُعرَضَ عملي وأنا صائِمٌ» [صحيح سنن أبي داود].
وعن أبي قتادة رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صَومِ الاثنينِ، فقال: «فيه وُلِدْتُ، وفيه أنزِلَ عليَّ» رواه مسلم.
صوم ثلاثة أيام من كل شهر
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدَعُهنَّ حتى أموتَ: «صومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، ونومٍ على وِترٍ» رواه الشيخان.
وعن مُعاذةَ العَدَويَّةِ أنَّها سألت عائشةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالت: نعم. فقُلتُ لها: من أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ كان يصومُ؟ قالت: لم يكُنْ يُبالي من أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يَصومُ. رواه مسلم.
والأفضل أن يوقع الصوم في الأيام البيض، وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
فعن ابن مِلحان القيسيِّ، عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمرُنا أن نصومَ البِيضَ: ثَلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخَمسَ عَشرةَ، قالَ: وقالَ: «هُنَّ كَهَيئةِ الدَّهرِ» [صحيح سنن أبي داود].
صوم يوم بعد يوم
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أحَبُّ الصِّيامِ إلى اللهِ صِيامُ داودَ: كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يَومًا» رواه الشيخان.
أحكام وتنبيهات عامة تتعلق بصوم التطوع
النية في صوم التطوع
قال ابنُ رشد رحمه الله: “وأمَّا الركن الثاني: وهو النيَّة، فلا أعلمُ أنَّ أحدًا لم يَشترط النيَّةَ في صوم التطوُّع”([6]).
تبييت النية في صوم التطوع
لا يشترط ذلك، وهذا قول الجمهور؛ الحنفية والشافعية والحنابلة.
والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء»؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائما»، فأكل. رواه مسلم.
وقت النية من النهار في صيام التطوع
يجوز لمن أراد الصيام أن ينوي صيام التطوع أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر، وهذا مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية، وقول طائفة من السلف واختاره ابن تيمية، وابن عثيمين([7]).
ولا دليل لمن اشترط أن تكون المية قبل الزوال.
فهل يحصل له ثواب صوم يوم كاملٍ أم يثاب من وقت نيته؟
مذهب الحنابلة: يثاب من حين نيته.
والصحيح عند الشافعية أنه يحصل له ثواب صوم اليوم كلِّه.
قال النووي رحمه الله: “ثُمَّ إذَا نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَحَّحْنَاهُ، فَهَلْ هُوَ صَائِمٌ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ فَقَطْ وَلَا يُحْسَبُ لَهُ ثَوَابُ مَا قَبْلَهُ؟ أَمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيُثَابُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا، (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْأَصْحَابِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ وَالْمُتَوَلِّي: الْوَجْهُ الْقَائِلُ يُثَابُ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ هُوَ قول أبي إسحاق الْمَرْوَزِيِّ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ هُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ. قَالُوا: وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْعِبَادَةَ قَبْلَ النِّيَّةِ، لَا أَثَرَ لَهُ، فَقَدْ يُدْرِكُ بَعْضَ الْعِبَادَةِ وَيُثَابُ؛ كَالْمَسْبُوقِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَيَحْصُلُ لَهُ ثَوَابَ جَمِيعِ الرَّكْعَةِ باتفاق الأصحاب، وبهذا ردوا على أبي إسحاق، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ”([8]).
وعليه:
فمن صام نفلاً مقيداً كعرفة وعاشوراء، ونوى أثناء اليوم فإنه يُرجى له حصول الأجر كاملاً على هذا المذهب، وعلى قول الحنابلة: لا يحصل له ثواب يوم عرفة كاملاً.
وفضل الله واسع.
هل يجوز التنفل بالصيام قبل القضاء؟
يجوز صوم التطوع قبل القضاء إذا كان الوقت واسعاً يسع القضاءَ بعد النفل، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد.
من شرع في صوم تطوع فيستحب إتمامه ولا يلزمه.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف([9]).
وذلك لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء»؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائما»، فأكل. رواه مسلم.
وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، قال: نم، فنام. فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق سلمان» رواه البخاري.
إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة؛ وهو قول طائفة من السلف؛ وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبا، لم يكن القضاء واجبا.
قال النووي رحمه الله: “قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما- أي في صوم تطوع أو صلاة تطوع- وأن الخروج منهما بلا عذر، ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما، وبهذا قال عمر وعلي، وابن مسعود وابن عمر، وابن عباس وجابر بن عبد الله، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق”([10]).
ربِّ صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] / استفدت كثيراً من الموسوعة الفقهية بموقع الدرر السنية في جمع مادة هذا الموضوع.
[2] / وهذا مقال كامل في الست من الشوال: http://mahranmahir.net/?p=1741
[3] / زاد المعاد (2/ 66).
[4] / شرح مسلم (8/ 71-72).
[5] / السلسلة الضعيفة، حديث رقم (404).
[6] / بداية المجتهد (1/ 311).
[7] / الموسوعة الفقهية – الدرر السنية.
[8] / المجموع شرح المهذب (6/ 292 – 293).
[9] / المجموع للنووي (6/ 493).
[10] / المجموع للنووي (6/ 394). وانظر: الموسوعة الفقهية بموقع الدرر السنية.